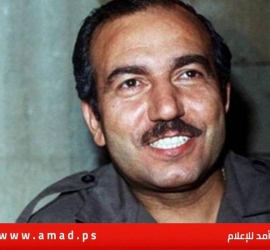الإنتخابات الإسرائيلية بتداعياتها الفلسطينية

معتصم حمادة
أمد/ 1- إنتخابات الكنيست 25 يمينية وفاشية
2- التحولات في المجتمع الإسرائيلي اليهودي
3- أية حكومة ... أي نظام سياسي في إسرائيل؟!
4- التحولات على الجانب الفلسطيني
5- في العلاقة المرتقبة بين إسرائيل والولايات المتحدة
6- بين العرب وإسرائيل
7- ما هو المطلوب فلسطينياً؟!
كانون الأول (ديسمبر) 2022
شكلت نتائج إنتخابات الكنيست 25، حدثاً سياسياً مهماً، كانت له أصداؤه المختلفة، بتداعيات متلاحقة، وضعت الحدث الإسرائيلي في مركز الاهتمامات الدولية والإقليمية والمحلية:
1- ما الذي ميّز هذه الانتخابات هذه المرة؟
2- وما هي النتائج التي أسفرت عنها، واستدعت هذا الاهتمام المميز؟
3- وكيف يمكن تفسير هذه النتائج التي تكاد تشكل إنقلاباً في الأوضاع السياسية الإسرائيلية، حتى في حسابات الدوائر الإسرائيلية نفسها؟
4- وكيف نفسر نجاح تحالفات اليمين المتطرف مع الفاشية اليهودية، وأحزاب الحريديم اليهودية، وما قابله في الجانب الآخر من تراجع لأحزاب اليمين والوسط الصهيوني العلماني؟
5- كيف نقرأ واقع حال الأحزاب العربية الفلسطينية في ظل النتائج التي حققتها في هذه الانتخابات، وهل يشكل هذا مؤشراً لتحولات في ميول الجماهير الفلسطينية العربية في إسرائيل؟
6- وأية حكومة إسرائيلية نتوقع، وهل هي في ظل ما توضح من تفاهمات واتفاقات بين أطرافها، أساساً للتحالف، هل نحن أمام نظام سياسي إسرائيلي جديد، أم أننا أمام حكومة دينية أصولية؟
7- ما هي ردود الفعل المرتقبة، دولياً وإقليمياً على حكومة دولة الاحتلال الجديدة؟ ما هي إنعكاساتها على اتفاقات أبراهام التطبيعية؟
8- أخيراً وليس آخراً، ما هو المتوقع فلسطينياً من جانب هذه الحكومة، وكيف ستكون طبيعة المواجهة الفلسطينية في ظل أوضاعها الحالية، لكل هذه التطورات؟ ]
(1)
إنتخابات بنتائج يمينية عنصرية
تميزت إنتخابات الكنيست 25، أنها الخامسة التي تجري في دولة الاحتلال، خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، بعد أن فشلت الدورات السابقة في توفير الشروط لقيام إئتلاف قادر على تشكيل حكومة مستقرة. وحتى الحكومة الأخيرة كانت نتاجاً لائتلاف هش، جمع أطرافاً سياسية متنافرة، فشلت في أن تُعمِّر طويلاً، واضطرت لتختصر إقامتها تحت سقف الكنيست إلى عامين ليس إلا، ترأس العام الأولى منها الصهيوني الاستيطاني نفتالي بينيت زعيم حزب «يمينا»، والعام الثاني حليفه يائير لابيد، زعيم حزب «يش عتيد»/ «هناك مستقبل» وليس أدل على هشاشة التحالف المذكور، سوى النتائج الصادمة لجمهوره، ولمتابعيه، الذي حققها في مواجهة تحالف الليكود، والأحزاب اليمينية العنصرية والصهيونية الدينية، وأحزاب الحريديم (شاس ويهوديت هتوراة).
حقق تحالف اليمين المتطرف واليمين الفاشي، أغلبية وازنة، قلما عرفتها الكنيست في دوراتها السابقة (64 مقعداً)، ما أشر إلى حتمية ولادة حكومة جديدة ومستقرة، بعد أن كثر الحديث عما يسمى «الانسداد التاريخي للنظام الإسرائيلي وفشله في الاستقرار»، بل ذهب كثيرون إلى اعتبار ما شهدته الكنيست من نكسات خلال الأعوام الثلاث، أنه مؤشر على انسداد وجودي لدولة إسرائيل.
نتائج الانتخابات، وقد أشرت إلى استقرار قد تشهده الكنيست في السنوات الأربع القادمة، أعطى مؤشرات معاكسة، بل دلل في جانب منها، على أن بعض التحليلات للحالة الإسرائيلية إستند إلى «حيثية أيديولوجية»، وليس إلى وقائع ملموسة، ما قد يعني ضعف الإلمام الفلسطيني بالواقع الإسرائيلي، وبنيته الاجتماعية وتحولاتها ومآلاتها، والتعويض عن ذلك بإسقاطات ورؤى وتنبؤات، أثبتت الوقائع فشلها.
إنها إنتخابات خاضها عدد من المطلوبين من القضاء الإسرائيلي، أو ممن أدانهم القضاء في أوقات سابقة، فرئيس التحالف بنيامين نتنياهو، يحمل على كتفيه قضية فساد كبرى (صفقة الغواصات الألمانية) وهي ما زالت عالقة أمام القضاء لم يبت بها بعد.
وبحق زعيم حزب «شاس» المتدين أرييه درعي، قرار بمنعه من تولي أية مسؤوليات عامة لإدانته بالفساد والسطو على المال العام، وهي ليست المرة الأولى التي يساق فيها درعي إلى القضاء، فلقد سبق وأدين في مرة سابقة بالسطو على أموال وزارة الأديان التي كان يتولاها، وسجن، واعتبرته «شاس» أثناءها بطلاً من أبطالها، بذريعة أنه حَوَّلَ الأموال المنهوبة لصالح المعاهد والمؤسسات الدينية للحزب.
كما أن إيتمار بن غفير، الذي سيتولى ما بات يسمى «وزارة الأمن القومي»، كان قد منع في مرات سابقة من الترشيح للانتخابات باعتباره إرهابياً (من اتباع كاهانا الإرهابي)، ورغم أن الحرم قد سقط عنه، إلا أنه ما زال يفتخر بانتمائه إلى حركة كاهانا ومعتقداتها، ولعل الاسم الذي اختاره لحزبه «قوة (أو عظمة) يهودية» دليل على نزعة التطرف القومي العنصري، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار شعاراته ودعواته إلى القتل والإعدام، لأدركنا الطبيعة الخطيرة، ليس لبن غفير وحده، بل للكتلة الناخبة التي حملته إلى الكنيست الإسرائيلي.
في السياق نفسه، وعلى الجانب الآخر من المشهد الحزبي الإسرائيلي يمكن أن نقرأ ما يلي:
إن التحالف الذي ضم نفتالي بينيت + يائير لابيد + بيني غانتس + أڤيغدور ليبرمان، قد إنفرط عقده مع تشكيل القوائم الانتخابية، إذ راح كل طرف من هذه الأطراف، إضافة إلى باقي أطراف التحالف (العمل + ميرتس ...) يحاول منفرداً أن يحقق الفوز لنفسه، خلافاً لتحالف الليكود والآخرين، وحتى عندما أسفرت الإنتخابات عن نتائجها، إمتنع «حلفاء» لابيد عن ترشيحه لرئاسة الحكومة في الاستشارات التي أجراها رئيس البلاد، ما أوضح وكأن تحالف اليمين المتطرف واليمين الفاشي، هو المنقذ لإسرائيل من أزمتها السياسية و«الوجودية»، وهو المؤهل لقيادتها في المرحلة القادمة، في وقت يعترف فيه الجميع أن العالم بأسره يشهد متغيرات، ستكون لها آثارها بالضرورة، على أوضاع المنطقة وفي القلب منها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما تمثله من مشروع إستعماري إستيطاني توسعي وعنصري، يتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، نحو فضاء الإقليم، والذي شكل أحد محاور التغيير في العالم.
مقابل الترحيب والاستقبال الواسع الذي لقيته نتائج الانتخابات من قواعد التحالف الفائز، إلا أنها بالمقابل إستقبلت بقلق شديد من باقي الأطراف السياسية الإسرائيلية اليهودية، لا بل بشيء من الذعر على مستقبل إسرائيل على يد الزمرة الفائزة في الانتخابات.
ولعل ما كتبته تسيبي ليڤني، الشخصية الإسرائيلية المشهورة، من تعليق على نتائج الانتخابات يمكن قراءته دليلاً ساطعاً على ذلك، فقد كتبت تقول: أنها بهذه النتائج تلقت ضربة قاصمة على بطنها، مما جعلها ترتعد خوفاً، مما ستحمله الحكومة الجديدة من دمار لإسرائيل، وللديمقراطية (!)، فإذا كانت هذه هي رؤية ليڤني، اليمينية المعروفة، المتحدرة من أصول ليكودية، فماذا يمكن أن تكون عليه باقي الأطراف في إسرائيل؟
ولم تقف مشاعر الخوف والقلق عند ليڤني وحدها، فقد امتدت إلى صف واسع من المعلقين والكتاب والصحفيين، بما في ذلك إفتتاحيات صحيفة «هآرتس»، التي شكلت العنوان الأبرز للتخوف اليهودي من المستقبل الظلامي الذي ينتظر إسرائيل على يد نتنياهو وزمرته
(2)
التحولات في المجتمع الإسرائيلي اليهودي
لماذا يتقدم الليكود على الأحزاب كافة في الكنيست، ويتراجع بالمقابل دور ونفوذ إتجاهات اليمين الليبرالي حتى ذلك الذي كان يتمثل بحزب الليكود؟ هذا ناهيك عن دور أحزاب الوسط ويسار الوسط واليسار الصهيوني بشكل مستمر، حتى أن ميرتس، الحزب اليهودي الصهيوني المعروف، فشل حتى في اجتياز عتبة الحسم! وما هي هذه التحولات التي قادت إلى ظهور صهيونية دينية في ظاهرة جديدة من ظواهر الصهيونية التي إعتنقها من يسمون «الآباء المؤسسون»، أمثال بن غوريون، وبيريس، ورابين وشارون وغيرهم؟
وما هي هذه التحولات التي جعلت من حزب «القوة اليهودية» وريث كاهانا الإرهابي، قوة سياسية تؤهلها كي تكون شريكاً أساسياً مع الليكود في تشكيل الحكومة، يتولى فيها وزارة الأمن الداخلي التي تحولت إلى وزارة الأمن القومي، وبالتالي ما هو معنى هذا التغيير في الاسم والعنوان والوظيفة، وأخيراً وليس آخراً، كيف تحافظ أحزاب الحريديم (شاس ويهودوت هتوراة) على قواعدها الانتخابية، في كل دورة من دورات الإنتخابات في الكنيست، وما هو سر تماسك هذه القاعدة خلف حزبيها؟
في محاولة للإجابة على كل هذه التساؤلات، نعتقد أنه لا بد لنا أن نعود إلى اللحظة المفصلية التي عاشتها دولة إسرائيل، أي حرب حزيران (يونيو) 67.
قبل ذلك، كانت إسرائيل دولة يقودها حزب العمل، بدوره النافذ في شبكة مستوطنات الكيبوتز، ويمسك بمؤسساتها المجتمعية، وأهمها الهستدروت (إتحاد العمال) الذي كان يشكل دولة داخل الدولة، وصندوق الضمان الاجتماعي، في ظل إقتصاد موجه كان جُلَّ همه أن يوفر للسكان خدمات تعمل على توفير الاستقرار لهم في دولة وليدة، تعيش عزلة إقليمية، وتسعى في الوقت نفسه لجذب ـ«يهود الخارج» للالتحاق بإسرائيل، باعتبارها دولة الأمان لهم في مواجهة موجات «اللاسامية»، كما كانوا يدّعون. وفي هذا السياق، بقي اليمين الإسرائيلي بتلاوينه المعروفة أقلية في الكنيست بسقف معارضة لا تملك القدرة على تغيير قوانين البلاد.
حرب 1967، وضعت إسرائيل (كما وضعت المنطقة بأسرها) أمام واقع سياسي جديد، فقد إتسعت إسرائيل الضامرة، لتمتد فوق كامل فلسطين الانتدابية، وإلى جانبها الجولان السوري، ومزارع شبعا في لبنان، وكل شبه جزيرة سيناء حتى قناة السويس غرباً، وهكذا ظهرت إسرائيل دولة إقليمية متفوقة على دول المحيط.
ولعل من أهم تداعيات التوسع الإسرائيلي، أنها سيطرت على الأراضي الفلسطينية، التي تعتبر في السردية اليهودية، الأراضي التلمودية. إسرائيل تحدثت عن «تحرير» أرضها التي كان يسيطر عليها العرب، وأطلقت على الضفة الفلسطينية اسمها التوراتي «يهودا والسامرة»، ورفضت الاعتراف بأنها دولة محتلة، ورفعت لواء حقها المشروع في الدفاع المسبق عن نفسها، وأن كل حروبها مع الجيران العرب هي «دفاعاً عن النفس».
مع الإنتصارات التي حققتها إسرائيل، شهدت تحولات إجتماعية وسياسية، إذ تدفق عليها المهاجرون اليهود من أنحاء العالم، وشهدت تكاثراً سكانياً ملموساً بدأت تظهر في صفوف شرائحه المختلفة التيارات المتدينة، بعد «النصر الإلهي» وإستعادة «أرض الميعاد» كاملة، وراكمت هذه الثقافة تحولات فكرية وسياسية، كان من نتائجها إتساع حجم الاستيطان بشكل جنوني، خاصة بعد اتفاق أوسلو، الذي أقر أن الأرض الفلسطينية المحتلة هي «أرض متنازع عليها»، ما يترتب عليه إقرار ضمني بحق إسرائيل فيها، وبدأت تتصاعد التيارات الأصولية، تأخذ أشكالاً منظمة كأحزاب الحريديم، وتأخذ شكل التيارات وأشكال مختلفة من الميليشيات المسلحة في المستوطنات، لحماية جيش الاحتلال، كما تحول المستوطنون أنفسهم إلى كتلة إجتماعية منظمة ومؤطرة ومؤثرة في البنية الحزبية والتشريعية والمؤسسية عموماً، بما فيه الجيش.
أما المحطة اللافتة للنظر، بعد إتفاقيات أوسلو وإندلاع الإنتفاضة الثانية، فكانت مؤتمر «هرتسليا» عام 2001، حين خرج باستنتاج أقره كبار جنرالات الإسرائيليين، أن الخطر الدائم على إسرائيل، هو الفلسطينيون العرب داخل إسرائيل، والذين يحملون جنسيتها، وراجت آنذاك أطروحة «القنبلة الديموغرافية الفلسطينية»، التي سوف تنفجر داخل إسرائيل، وارتاحت القوى العربية والفلسطينية الخاملة فكرياً لمثل هذه الأطروحة، وبدأت تتحول إلى رؤية تراهن على هذه «القنبلة» وصولاً إلى إبتداع فكرة رسم سقف زمني لعمر إسرائيل. إلى جانب ذلك شهدت إسرائيل تحولات إقتصادية بدأت تنتقل معها إلى نظام السوق الرأسمالي الليبرالي الحر، تماشياً مع تحولات الغرب الأميركي والأوروبي، الأمر الذي أسهم في بناء شرائح إجتماعية، تمتد من أعلى القمة الرأسمالية إلى أدنى، حيث الفئات الفقيرة والمعوزة مثلها مثل أي مجتمع رأسمالي في العالم.
لكن الملاحظ في السياق، أنه رغم سياسة التمييز التي تمارسها إسرائيل حتى بين اليهود أنفسهم، لم تشهد ردود فعل صاخبة، كالإضراب عن العمل والتظاهر الصاخب دفاعاً عن حقوق الفئات الاجتماعية المتضررة، إذ يبدو واضحاً أن التعبئة الداخلية بين اليهود المهددين بـ«الخطر الخارجي» أسهمت في امتصاص عناصر الصراع الاجتماعي، بمفهومه الطبقي الكلاسيكي، لصالح عناصر «الصراع مع الخطر الخارجي»، ممثلاً بالفلسطينيين والعرب، الذين يتربصون بإسرائيل في غفلة من الزمن، بينما تؤكد الوقائع عكس ذلك بدليل الانفتاح العربي على إسرائيل (إتفاقيات أبراهام).
أما المحطة المفصلية الأخرى التي أسهمت في تسريع التحولات داخل إسرائيل، هي إعلانها «دولة قومية لليهود»، بما فيه يهود العالم، ودولة لليهود فقط، مما عزز دور التيارات اليمينية والنزعات الفاشية، والتي بدأت تنظر إلى الوجود العربي الفلسطيني في إسرائيل في «يهودا والسامرة»، وجوداً فائضاً، عليه أن يغادر أرض إسرائيل، التي تتعاظم قوتها العسكرية والاقتصادية، ويتعزز فيها دور اليمين، واليمين الفاشي، ودور أحزاب الحريديم، الذين رأوا في إعلان الدولة القومية اليهودية، ما يلبي تطلعاتها.
وبالتالي فإن ما شهدناه من نتائج جديدة في إنتخابات الكنيست 25، ما هو إلا نتاج لتحولات إجتماعية داخل إسرائيل نفسها، ولم يعد غريباً على سبيل المثال، أن يوافق 55% من الإسرائيليين اليهود على مبدأ إطلاق النار على الفلسطينيين على الشبهة، ولم يعد مستغرباً أن يوافق 71% من الإسرائيليين اليهود على مبدأ إعدام الأسرى المتهمين بقتل يهود، وأن يتحدث بن غفير علناً عن تهجير الفلسطينيين من القدس ومن أنحاء الضفة، وأن يعلن مخططه للاستيلاء على الأقصى لإزالته واستعادة الهيكل الموعود.
أي إننا لسنا أمام ظواهر حزبية إسرائيلية عابرة، بل نحن أمام تحولات إجتماعية عميقة من شأنها أن تبني «إسرائيل الجديدة»، الدولة القومية اليهودية الفاشية، الممتدة على كامل أراضي فلسطين، وتقوم على مبدأ تهجير «الفائض» الفلسطيني من «أراضي الدولة»
(3)
أية حكومة ...
أي نظام سياسي في إسرائيل؟!
كان لافتاً، ليس حجم الإعتراض واتساع ردود الفعل على تشكيل الحكومة الجديدة فحسب، بل وكذلك تأكيد نتنياهو لخصومه السياسيين، أن إسرائيل لن تكون دولة أصولية، وأن يذهب نتنياهو إلى هذا الحد، معناه أن قوى سياسية وشرائح إجتماعية بدأت تتخوف من أن تؤدي هذه الحكومة، بتشكيلها الجديد إلى مزيد من الإنحدار السياسي بإسرائيل نحو دولة أصولية ظلامية.
ولعل ما يسهل على نتنياهو وشركائه، تغيير النظام السياسي في إسرائيل نحو دولة أصولية، هو أن إسرائيل ما زالت حتى الآن دولة بلا دستور وبلا حدود رسمية تعلنها حدودها الدولية، وهذا بطبيعة الحال ينسجم مع أهداف المشروع الصهيوني، الذي من شأنه أن يتطور، وتتطور أهدافه، مع التقدم في تحقيق ما يصبو إليه من مشروعات استيطانية توسعية، من تحويل إسرائيل إلى دولة قومية يهودية، دولة لكل يهود العالم، و«ممثلة» لهم.
تعتمد إسرائيل ما يسمى بالقوانين الأساس، ويتناول كل قانون موضوعاً «دستورياً» بحيث تشكل هذه القوانين البديل للدستور الإسرائيلي الدائم، وهي قوانين يجري تعديلها كلما دعت الحاجة الإسرائيلية إلى ذلك، وكثير من الأحيان يجري تعديلها لتخدم مصالح بعض الأحزاب، وبشكل خاص أحزاب اليمين، آخذين بالإعتبار أن إسرائيل قد إنتقلت من دولة ذات إقتصاد موجه إلى دولة رأسمالية ليبرالية، تُعلي القطاع الخاص، وتشكل جزءاً مهماً من السوق الرأسمالية العالمية، خاصة في صناعة السلاح والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي هذا الإطار عَدَّل الليكود، القانون الأساس الخاص بتشكيل الحكومة، إذ رفع عدد الوزراء من 25 وزيراً إلى 30 وزيراً، وأحياناً أكثر، في خدمة تحالفاته الحزبية ولو على حساب الخزينة الإسرائيلية.
وأجرت إسرائيل تعديلات في نظام إنتخاب رئيس الحكومة، إذ جعلته مباشرة من جمهور الناخبين، بعد أن كان رئيس الكتلة الأكبر في الكنيست يتولى هذا المنصب، وهدفت إسرائيل من هذا التغيير إلى تحرير الأحزاب الكبيرة من إشتراطات الأحزاب الصغيرة في بناء التحالفات في الكنيست، لتكتشف هذه الأحزاب (الليكود والعمل آنذاك) أن قبضة الأحزاب الصغيرة بقيت قوية، وأن دورها في تقرير مصير رئيس الحكومة بالانتخاب المباشر لم يتراجع، فعادت إسرائيل إلى نظامها السابق: رئيس الكتلة الأكبر في الكنيست هو من يشكل الحكومة، إذا ما استطاع أن يبني تحالفاً للأكثرية.
كذلك عَدَّلت إسرائيل نسبة الحسم في الانتخابات التشريعية، فرفعتها إلى 3,25%، ظناً من الذين اقترحوا ذلك أن بإمكانهم تقليص التمثيل الفلسطيني في الكنيست، الأمر الذي لم ينجح، لا بل ساهم في بعض المحطات بتعزيز تمثيل القوائم الفلسطينية.
الآن، تقبل إسرائيل على تعديلات في قوانينها، إرضاء لتحالف اليمين المتطرف والفاشي، وهي تعديلات سيكون لها أثرها في بنية السلطة الإسرائيلية، وتداعيات على بنية النظام السياسي بما في ذلك دور الجيش في صنع القرار في البلاد.
فثمة مشروع تم تحضيره يهدف إلى تهميش دور المحكمة الإسرائيلية العليا، بما يمكن أغلبية القضاة في إسرائيل نقض قراراها وأحكامها بصورة تبدو «قانونية»، وثمة مشروع آخر يجري تحضيره لتهميش «المراقب القضائي للدولة» لصالح تعيين نائب عام إلى جانبه، تتيح له السلطة نقض أو تهميش قرارات «نظيره المراقب».
وهذا كله لتبرئة نتنياهو المحال إلى المحكمة العليا بتهم فساد متعددة، وأيضاً من أجل نقض القرار القضائي بمنع رئيس حزب شاس من تولي مسؤولية عامة (وزارة مثلاً) بعدما أدين بالفساد المالي، والتهرب من الضرائب. كذلك يعمل نتنياهو وحلفاؤه على إدخال تعديلات على البنية العسكرية لإسرائيل وعلى صلاحية وزارة الدفاع، منها مشروع قانون يلحق «حرس الحدود» (البالغ تعداده حوالي ثلاثة آلاف) بوزارة الأمن، بعد أن كان ملحقاً بوزارة الدفاع، ولقد سبق ذلك أيضاً تغيير اسم وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الأمن القومي لتنسجم مع مهماتها، فأضحت مسؤولة عن الأمن الداخلي في إسرائيل، وأمن المستوطنات وعن مشاريع الاستيطان في أنحاء الضفة والنقب.
ولا شك أن إلحاق النقب، كجزء من دولة إسرائيل، بالضفة الفلسطينية، في ظل قانون إستعماري إستيطاني واحد، وفي ظل وزارة أمنية واحدة، لا يمكن تفسيره سوى أنه خطوة لاعتبار الضفة الفلسطينية، بمستوطناتها ومواقعها العسكرية أرضاً إسرائيلية. كذلك أعطيت وزارة الأمن القومي صلاحيات تشكيل مجموعات ميليشيا مسلحة من المستوطنين، بدعوى حماية المستوطنات من «الإرهاب» الفلسطيني.
ولا يقل أهمية عن كل ما سبق، أن إيتمار بن غفير هو من يتولى وزارة الأمن القومي، بما يعنيه ذلك من إحتمالات متعددة الاتجاهات، ليس على الجانب الفلسطيني وحده، بل وكذلك في العلاقة مع الجيش الإسرائيلي التي يفترض أن الضفة الفلسطينية تخضع لسلطته ومرجعيته، أو حتى على الصعيد الإسرائيلي، ترى ما هي التداعيات داخل إسرائيل عندما يتحول المستوطنون الأصوليون، والفاشيون، ودعاة تهجير الفلسطينيين إلى ميليشيا مسلحة داخل الدولة؟ وأي إنعكاس سوف تلحظه التداعيات القادمة على العلاقات الاجتماعية داخل إسرائيل وعلى العلاقات بين أحزاب الموالاة، اليمينية المتطرفة والفاشية، وجمهورها الانتخابي، والأحزاب الإسرائيلية الأخرى، في المعارضة؟ دون أن يغيب عن بالنا تداعيات ذلك على «المواطنين» الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل.
أما التعديل الآخر، والذي سيكون له طابع استراتيجي في عمل الحكومة، فهو إلحاق الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الفلسطينية بوزارة المال، بإدارة زعيم «الصهيونية المتدينة» بتسلئيل سموتريتش. تأتي هذه الخطوة في إطار تسوية أبعدت سموتريتش عن وزارة الدفاع (تحت ضغط الولايات المتحدة وقيادة الجيش) وبين مد سلطته على الأوضاع في الضفة الفلسطينية، وبالتالي ملف الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أكثر الأحزاب يمينية وفاشية وتطرفاً: «القوة اليهودية» في خطوة من المرتقب أن تترجم تصعيداً إسرائيلياً على كافة الصعد، ضد الفلسطينيين في الضفة، مما يفسح المجال لإسرائيل لتخوض حرباً جديدة ضد الشعب الفلسطيني «بلا قواعد» هذه المرة، إلا قاعدة واحدة وهي «إلغاء الوجود الفلسطيني» داخل إسرائيل اليهودية.
في السياق نفسه، لا يمكن أن نتجاهل الحاخامات في إسرائيل، وقد أصبحوا أصحاب سطوة، تلزم فتاويهم الطوائف اليهودية المتدنية. آخر هذه الفتاوى؛ التحريم على الجنود الالتحاق بسلاح المدرعات بعد أن أجازت رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، السماح للمجندات الخدمة في هذا السلاح.
ومن مظاهر التطرف الديني، إعتداء المتدينين على محلات الغذاء اليهودية التي تبيع مواداً محرمة دينياً، دون تدخل من الشرطة أو رجال الأمن، وهو ما اعتبره العلمانيون في إسرائيل مؤشراً خطيراً لولادة دولة أصولية على رأسها نتنياهو، لكن يقودها أطراف التحالف، اليمين المتطرف، واليمين العنصري، وأحزاب الحريديم وباقي القوى الظلامية
(4)
التحولات على الجانب الفلسطيني
كانت النتائج التي أحرزتها الأحزاب العربية في الانتخابات صادمة، إذ فشل حزب التجمع في تجاوز عتبة الحسم، وفازت كل من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة بـ 5 مقاعد، ما أدى إلى تراجع التمثيل العربي في الكنيست، ولهذا أسبابه، وله كذلك إنعكاساته.
لا يمكن تفسير هذه النتائج بالاكتفاء بالقول أن الأحزاب العربية فشلت في الائتلاف في قائمة مشتركة، وأنها خاضت المعركة بثلاث قوائم منفصلة عن بعضها البعض، وأن المعركة دارت بين هذه القوائم الثلاث لتجاوز نسبة الحسم؛ فالانقسام في حد ذاته يعكس حالة سياسية أدت إلى ما أدت إليه.
لقد دخلت أطراف القائمة المشتركة في نزاع فيما بينها حول الأداء المطلوب في الكنيست، ففي الوقت الذي أصر فيه حزب التجمع على سياسة متشددة، في رسم إستراتيجيته القائمة وتكتيكاتها في الكنيست، بما في ذلك العزوف عن التصويت لصالح أي من الأطراف اليهودية، حتى ولو تقاطعت معه المواقف، رأت الحركة العربية للتغيير (أحمد الطيبي) ضرورة إمتلاك مرونة توفر للقائمة هامشاً للمناورة، خاصة بعد أن التحقت القائمة العربية الموحدة (التيار الإسلامي الجنوبي) بالائتلاف الحكومي بذريعة تحقيق مكاسب للجماهير العربية، أدى الخلاف إلى خروج «التجمع» من القائمة المشتركة، ودخول المعركة بقائمة خاصة، وكانت النتائج لافتة للنظر:
• فالتجمع رغم خوضه المعركة منفرداً، كاد أن يجتاز عتبة الحسم، إذ فاز بـ 136 ألف صوت، وهو أقل بثلاثين ألف صوت تقريباً عن القائمة المشتركة.
• إجتازت القائمة المشتركة عتبة الحسم بـ 176 ألف صوت، وفازت بـ 5 مقاعد فقط.
• أما القائمة الموحدة (الإسلامية) فقد فازت بـ 196 ألف صوت، وفازت هي الأخرى بـ 5 مقاعد.
في قراءة للأرقام يمكن أن نخلص إلى ما يلي:
• إن التجمع رغم فشله في دخول الكنيست، حقق نتيجة ذات مغزى، فقد أثبت أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية مهمة، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار حديث الحزب عن العدد الكبير للمتطوعين الذين التحقوا به في معركته، وعن تواضع الميزانية التي صرفها لتغطية نفقات المعركة، وإذا ما أخذنا بالاعتبار الخطاب السياسي للحزب، يمكن أن نخلص إلى أن القاعدة الجماهيرية التي انحازت له كانت قاعدة ذات شأن، وهي تشكل أحد التيارات الرئيسية في البنية الاجتماعية للجماهير العربية في إسرائيل.
• إن ما حققه الشريكان في القائمة المشتركة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة + الحركة العربية للتغيير)، يعد مقارنة بما حققه «التجمع» من جهة، والموحدة من جهة أخرى، أقل من المتوقع، وهو أياً كان سبب ذلك يعكس حال قاعدة جماهيرية ليست بالحجم الذي كان يفترض أن ينحاز للقائمة المشتركة، ولا يمكن أن نعزو ذلك إلى أخطاء وإرباكات إدارية، بل إلى إستراتيجية القائمة المشتركة وخطابها الجماهيري، ومدى تأثير دورها في الحالة الجماهيرية.
• الملاحظة الأخرى التي تقتضي وقفة وتأملاً، هي فوز القائمة الموحدة، منفردة بـ 5 مقاعد، ليس هذا فحسب، بل وكونها حققت أعلى الأصوات بين القوائم العربية، ما يضعها في مقدمة القوى السياسية العربية بمعيار القاعدة الانتخابية، وأيضاً لهذا أسبابه، ويحتاج بالضرورة إلى نقاش.
مما لا شك فيه أن مكان النقاش العملي المنتج، يفترض أن يكون لدى الأحزاب العربية داخل إسرائيل، مع باقي مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية فيها؛ اللجنة العليا للمتابعة، المجلس القطري لرؤساء البلديات، المؤسسات والفعاليات الاجتماعية والنقابية والثقافية، وكل من له صلة بالشأن العام والحرص عليه.
غير أن هذا لا يحول دون أن نتوقف أمام ظاهرة «القائمة الموحدة»، إذ ما بتنا نعتبرها ظاهرة، إذ إنفصلت «القائمة الموحدة» عن «القائمة المشتركة» في إنتخابات الكنيست 24، وفازت بـ 4 مقاعد. ليس هذا فحسب، بل أعلنت دخولها الائتلاف الحكومي إلى جانب نفتالي بينيت + يائير لابيد + بيني غانتس + أڤيغدور ليبرمان وآخرين، وذلك في سياق سياسة تقوم على وصم إستراتيجية الأحزاب العربية الأخرى في الكنيست بالانعزالية والجمود، وفشلها في تقديم الخدمات الواجب تقديمها عبر الحكومة، للبلدات والقرى العربية، وأن الباب إلى ذلك هو الإنخراط في اللعبة السياسية عبر الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، حتى ولو من دون تمثيل وزاري.
ومع الانتخابات الحالية، وبما أنتجته من حكومة متطرفة وفاشية، جدد منصور عباس رئيس القائمة الموحدة إستعداده للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، برئاسة نتنياهو مقابل «مكاسب» تقدم إلى الجماهير العربية.
إن النهج السياسي الذي بدأت «القائمة العربية الموحدة» تتبعه، لا يمكن قراءته سوى أنه استسلام للمشروع الصهيوني، وارتماء في أحضانه، بحثاً عن مكاسب آنية، ولو أدى ذلك إلى تذويب الشخصية الوطنية للجماهير العربية.
هذا النهج يشكل إعلاناً للتخلي عن البرنامج الكفاحي للجماهير العربية في النضال، من أجل المساواة في الحقوق القومية كأقلية عربية، إلى جانب المساواة في المواطنة، دون أي تمييز عرقي أو ديني أو عنصري، ولصالح القبول بالخدمات الحياتية والمكاسب الفردية بديلاً لهذه الحقوق.
ولا شك أن ما حققته «القائمة العربية الموحدة» من أصوات، أكد بشكل واضح أن سياستها تلقى قبولاً لدى فئات إجتماعية عربية فلسطينية، بدأت تنظر إلى مصالحها الآنية والفئوية والشخصية، عبر تخطي الجانب القومي، وعبر الاستسلام للمشروع الصهيوني.
ليست هي المرة الأولى التي يرتبك بها الوعي في صفوف الجماهير العربية، وتقف بين خيارين منفصلين: إما الاستسلام للمشروع الصهيوني مقابل المكاسب الحياتية التي قد تنهال بسخاء، وإما التمسك بالمشروع الوطني والقومي، حرصاً على الحقوق الوطنية لشعب فلسطين تحت نظام عنصري، يقوم على تهميش العرب باعتبارهم «أغيار» وليسوا أبناء للدولة.
لقد اجتاح القوى السياسية والجماهيرية العربية، هذا الارتباك بعد التوقيع على «اتفاق أوسلو»، حيث أحس من هم وراء الخط الأخضر، من جماهير عربية أن م. ت. ف قد تركتهم لمصيرهم في مواجهة الدولة العنصرية، وذهبت تبحث عن حل منفرد لمن هم خارج الخط الأخضر. وبناء عليه، لم يعد أمام الجماهير العربية في إسرائيل سوى أن تبحث هي الأخرى عن حل لأوضاعها، في سياسة تقوم على النضال لأجل المصالح الاجتماعية، ولو على حساب الحقوق القومية.
هذه المرة، لا يمكن تفسير سياسات «القائمة الموحدة» سوى أنها تعبير عن حالة سياسية انتهازية ذات مصالح فئوية محدودة، تمثلها قيادة الحركة الإسلامية، إفتقرت إلى الثقة بالنضال القومي، والثقة في قدرة النضال مع الحركة الجماهيرية في تصويب الأوضاع القومية للوجود الفلسطيني داخل إسرائيل، وسلكت الطريق الأقصر نحو الجلوس في الصف الخلفي للائتلاف اليهودي بانتظار جمع الفتات عن مائدة توزيع الغنائم على الأحزاب اليهودية، واعتبار ذلك الكم من الفتات مكاسب إجتماعية يحققها إلتحاقها بالائتلاف.
لكن مع ذلك، علينا أن نلاحظ أن فئات إجتماعية نافذة في المجتمع الفلسطيني، بدأت تميل لصالح خطاب الحركة الإسلامية، خاصة الفئات الوسطى النامية في صفوف الجماهير العربية، من أطباء وممرضين (حسب الإحصائيات يشكل هؤلاء في مجموعهم 50% من كتلة العاملين في مجال الصحة في إحداث تغيير ما في البنى الاجتماعية الفلسطينية في إسرائيل، يحتاج من الجهات المعنية إلى دراسة وتدقيق، وبناء عليه رسم استراتيجيات وخطط وسياسات تحاصر الدور السياسي والاجتماعي للحركة الإسلامية، لصالح تعزيز دور مجموع القوى السياسية القومية والتقدمية والديمقراطية واليسارية وغيرها، صوناً للبنى الاجتماعية الفلسطينية من الديماغوجية السياسية التي بدأت الحركة الإسلامية تشكل عنوانها الأبرز.
وأخيراً، لم تقف نتائج الإنتخابات عند هذه الحدود، بل أعادت إلى الحياة السياسية شخصيات غابت عن المسرح السياسي فترة غير قصيرة، حين أعلن طلب الصانع عن تشكيل حزب عربي – إسرائيلي اسمه «دولة لكل مواطنيها»، وإن لم يتم حتى الآن الكشف عن برنامجه واتجاهات عمله، إلا أن العنوان وحده يشي وكأنه يلتقي مع سياسات الحركة الإسلامية، في الاعتقاد أن «المساواة» سقفها «العدالة في الخدمات» مقابل تذويب الشخصية الوطنية الفلسطينية وأسرلتها
(5)
في العلاقة المرتقبة بين إسرائيل والولايات المتحدة
لا شك أن بعض دوائر الحزب الديمقراطي إرتابت بوصول التحالف اليميني المتطرف إلى الحكم في إسرائيل، لما سيشكله ذلك من إرباك لاستراتيجية الولايات المتحدة في إدارة الأزمة في الشرق الأوسط، وتأجيل «الحل الدائم» إلى مرحلة تعتقد فيها واشنطن أن شروط الحل قد إنعقدت، وبات ممكناً التوصل إليه دون إضطرابات أمنية أو سياسية، وهو ما يفسر الحديث الدائم لواشنطن ومبعوثها عن إمكانية «حل الدولتين»، ولكن في «المدى غير المنظور»، ويستبدل ذلك بالحديث عن الازدهار والأمن للشعبين في إطار «حل اقتصادي» في الضفة الفلسطينية، مقابله «الأمن مقابل الغذاء» في قطاع غزة.
نزعت بعض دوائر السلطة الفلسطينية إلى الرهان على الارتياب الأميركي في اعتقاد ساذج، بإمكانية كسب الولايات المتحدة، وإبعادها عن إسرائيل لصالح «تفهمها» للقضية الفلسطينية، خاصة بعد أن «انكشفت» الحقيقة الإسرائيلية.
لكن سرعان ما انهار هذا الوهم، حين أعلن السفير الأميركي في إسرائيل عن استعداد بلاده للتعامل مع نتنياهو وحكومته، مؤكداً في السياق نفسه أن العلاقة الأميركية – الإسرائيلية ليست بين أفراد، في إشارة إلى وقوف نتنياهو إلى جانب ترامب في الانتخابات الرئاسية، ووقوفه إلى جانب الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، أكد السفير الأميركي أن العلاقة هي بين دولتين، عبر المؤسسات. ومعروف أن إسرائيل ترتبط بالولايات المتحدة بعلاقات استراتيجية عميقة الجذور في كافة الجوانب دون استثناء، وبالتالي من الخطأ الرهان على علاقات أميركية – إسرائيلية مأزومة، دون أن يعني هذا أنها لن تمر بأزمات عابرة، كالعديد من الأزمات السياسية التي وإن تلونت أشكالها فإنها لم تؤثر على العلاقات الاستراتيجية للطرفين.
ليس المطلوب فقط عدم الرهان على خلافات أميركية – إسرائيلية، قد يتم «إستغلالها» لصالح التقرب من الولايات المتحدة، بل المطلوب أساساً عدم الرهان على الوعود الأميركية، خاصة وعودها بـ«حل الدولتين» (!)، والذي رسم نتنياهو ومن قبله نفتالي بينيت، وبعدهما لابيد، ملامحه بحيث لا يتجاوز حدود الحكم الإداري الذاتي على السكان، في مدن الضفة، دون الأرض، تحت مظلة الأمن الإسرائيلي، وفي قبضته وبما يطال كل مظاهر الحياة الفلسطينية، سياسياً، وتربوياً، وثقافياً، واقتصادياً وأمنياً، بما في ذلك إرتباطهم بالخارج، وبباقي ملفات القضية الوطنية، خاصة ملف اللاجئين وحق العودة
(6)
بين العرب وإسرائيل
بناءً لتصريحاته التي كررها أكثر من مرة، تحتل الحالة العربية موقع الاهتمام في السياسة المرتقبة لنتنياهو وحكومته، فهو يتطلع نحو توسيع دائرة التطبيع مع الأنظمة العربية (والمسلمة إن أمكن)، عملاً بتحالفات «أبراهام»، وفي مقدمة الدول العربية التي يتطلع لها نتنياهو المملكة العربية السعودية، لأهمية موقعها، نفوذها، تأثيرها في المحيط الإقليمي، وما هو أبعد. نتنياهو يدرك بطبيعة الحال ما يمثله موقع السعودية في هذا المجال، إذ يعتقد أن ذلك سيفتح الطريق ليس إلى العالم العربي فقط، بل إلى العالم الإسلامي، بعد أن تم التطبيع مع دولة «خادم الحرمين الشريفين».
الملاحظ في هذا السياق، أن العواصم العربية، ما عدا الدول التي حسمت موقف المقاطعة لإسرائيل (كسوريا والجزائر على سبيل المثال)، لم تعلن موقفاً من الزمرة السياسية الجديدة القادمة إلى السلطة في إسرائيل، ولعل هذه العواصم تترقب ما سوف تؤول إليه الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مواجهة حكومة نتنياهو، لذلك يمكن القول باختصار شديد، إن عواصم العالم العربي ستبني مواقفها من حكومة نتنياهو في ضوء سياسات نتنياهو وحلفائه من الفلسطينيين، وبالتالي فإن أي تصعيد دموي فاجر، يقابله صمود وثبات وتصعيد فلسطيني قاتل، سوف يرغم العواصم العربية بما فيها تلك التي تربطها اتفاقات تطبيع، أو تحالفات مع إسرائيل، لتتخذ مواقف تعفيها من الحرج أمام الرأي العام، خاصة مع شعوبها دون أن يصل بنا التوقع أن تراجع هذه العواصم، خاصة المتحالفة مع إسرائيل في إطار «أبراهام»، مواقفها من إسرائيل، وإن كان البعض قد يسحب سفيره من إسرائيل، وهو أقصى ما يمكن توقعه.
الخلاصة: الرهان على الحالة العربية مشروط بإدامة المقاومة الشاملة للاحتلال، وتصعيدها وتطويرها وتأطيرها، في سياسة فلسطينية تضع كافة أطراف الأزمة في الزاوية الحرجة
(7)
ما هو المطلوب فلسطينياً ؟
لا نحتاج إلى العودة إلى الصفر لنبدأ من جديد في استخلاص ما هو المطلوب، فنحن نعيش مقاومة شعبية شاملة، بما فيها ظاهرة المجموعات المسلحة، وهي تلقى ترحيباً وإحتضاناً شعبياً غير محدود، وبحيث باتت المقاومة هي الخيار السائد، الذي لا يستطيع أي طرف أن يتجاوزه، وإن كانت بعض خطابات الرئاسة تتحدث عن المقاومة الشعبية السلمية ثم تستدرك، في إلتفاتة مكشوفة المقاصد، للحديث عن إمكانية توسيع دائرة المقاومة وأساليبها.
تمتلك المؤسسة الفلسطينية سلسلة من القرارات الاستراتيجية، أقرها المجلس الوطني - 2018، وأعاد التأكيد عليها المجلس المركزي - 2022، بدءاً من وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، مواصلة التحرك في المحافل الدولية (إستكمال تنسيب دولة فلسطين للوكالات الدولية ذات الاختصاص «وكالة حقوق الملكية، وكالة الغذاء، وكالة الطيران» + العضوية العاملة في الأمم المتحدة + طلب الحماية الدولية، توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية + تعزيز موقع وكالة الغوث ودورها، وإغناء مصادر تمويلها + تدويل ملفات القضية خاصة ملف الأسرى وملف جثامين الشهداء المحجوزة لدى الاحتلال + جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية وغيرها من المحاكم الأجنبية ذات الصلاحية ... الخ.
حكومة فلسطينية ذات استراتيجية تكفل دعم صمود وثبات المقاومة الشعبية، ورسم خطط الانفكاك عن الاحتلال، حكومة وطنية نظيفة اليد، محصنة ضد الفساد، معنية بشؤون المجتمع وقضاياه، معفاة من أي دور يزاوج بينها وبين الدور الواجب أن تقوم به اللجنة التنفيذية، بما في ذلك العلاقات الخارجية التي يفترض أن تتولاها الدائرة السياسية في م. ت. ف.
إعادة النظر في تموضع بعض المؤسسات الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتسهيل تحركها على المستوى الشعبي والدولي، مثال: دائرة شؤون المغتربين، الدائرة السياسية، دائرة العلاقات الدولية والعربية وغيرها، كما هو حال رئاسة الصندوق القومي، ورئاسة المجلس الوطني، حيث يفترض أن تكون أكثرية أعضاءه في الخارج، وحيث يمكن انتظام دوراته حتى في ذروة الاضطراب الأمني في الأراضي المحتلة.
توفير حل لإنهاء الإنقسام، بما يضمن تعزيز الوحدة النضالية الميدانية بين الضفة والقطاع، واعتماد إستراتيجية نضالية لترجمة وحدة الساحات والجبهات، بين الضفة والقطاع، وأراضي 48 والشتات، وعموم الخارج.
إن كل هذا يتطلب بالضرورة حواراً وطنياً جاداً وذا مغزى، وعلى أرقى المستويات المسؤولة، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وتسليحه باستراتيجية وطنية جامعة، في مواجهة مرحلة مفصلية، تؤكد كل المقدمات أنها ستكون نوعية في كافة جوانبها