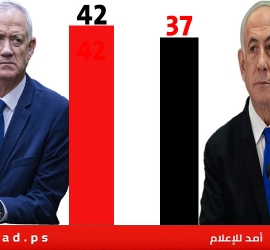الوجهة الفلسطينية- الإسرائيلية المغايرة
حازم صاغية
في الوضع الراهن الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط، وسط عزوف عنها شامل وعريض، وفي موازاة حرب جوية تشنها الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، حصلت تطورات من نوع آخر على الجبهة الفلسطينية.
فقد اعترفت بفلسطين دولةٌ أوروبية كالسويد، تتمتع بوزن أخلاقي وقيَمي مشهود له عالمياً. كما صوّت مجلس العموم البريطاني بأغلبية كاسحة من جميع أحزابه (274 عضواً مقابل رفض 12 عضواً) لصالح هذا الخيار، وإن اتخذ الأمر شكل التصويت الرمزي. وبدورها علقت فرنسا الرسمية على ما جرى في البرلمان البريطاني، فرأت أن المطلوب قرار عملي وليس رمزياً فحسب، موحية بذلك بأنها قد تتخذ قريباً خطوة كبرى في هذه الوجهة نفسها.
وهذا معطوف على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل عامين، الاعتراف بفلسطين دولةً ذات سيادة، فضلاً عن اعتراف سابق لـ134 دولة في العالم.
في الوقت ذاته تقريباً انعقد مؤتمر للمانحين في القاهرة قررت بموجبه خمسون دولة تقديم تعهدات بتوفير مبلغ 5,4 مليار دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزّة، بعد التدمير الذي أنزلته به الحرب الإسرائيلية الأخيرة. صحيح أن الأمر لا يزال «تعهدات»، إلا أن التعهدات هي إلزامات نظرية ومبدئية قابلة للتفعيل حين تتكامل الشروط المطلوبة لها.
وفي السياق هذا كان ملحوظاً أن يتمّ رهن المبالغ المذكورة وتقديمها بعوامل ثلاثة مترابطة:
الأول، أن يُمارس في غزة حكم السلطة الفلسطينية الذي أبعد عنها بالقوة، وهو ما ينجم عنه عملياً توحيد سياسي وإداري ومؤسسي للقطاع مع الضفة الغربية. وهذا ما تشكل الحكومة الائتلافية، في حال إقلاعها ونجاحها، الخطوة الأولى على الطريق إليه. أما العامل الثاني، فأن تنشأ هدنة طويلة بين السلطة الفلسطينية (وقد صارت غزة نظرياً في عهدتها) وبين إسرائيل. ذاك أن من الطبيعي جداً ألا ينفق المانحون أموالهم لبناء ما سيتهدم بعد وقت قصير. وأما العامل الثالث والأخير، فأن يُستأنف التفاوض والعملية السلمية الفلسطينية- الإسرائيلية من أجل التوصل إلى قيام الدولتين المتجاورتين.
وما من شك في أن الإنجازات المذكورة أعلاه، على تواضع بعضها ورمزية بعضها الآخر، هي هدايا ممنوحة للسلطة الوطنية، ومن خلالها للشعب الفلسطيني. فالسلطة هذه، على الرغم من ضعفها وضيق الخيارات السياسية المتاحة أمامها، هي موضع طلب دولي.
وربما قامت الفلسفة الضمنية لهذا السلوك، منظوراً إليه من ضمن نطاق المنطقة الأعرض، على أن دعم السلام والاستقرار في فلسطين- إسرائيل هو النقيض المطلوب لما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من حروب ومواجهات تسببت بها أنظمة الاستبداد وتنظيمات التطرف والتكفير.
ولكنّ الجانب الذي لا يزال بحاجة إلى الاختبار إنما يتعلق بموقفي الطرفين الأقصيين، أي إسرائيل وحركة «حماس». فقد بات واضحاً أن حكومة نتنياهو الليكودية (والتي، بالمناسبة، لم تُدع إلى مؤتمر المانحين) مستاءة جداً من الانفراجات التي تحصدها القضية الفلسطينية على الجبهة الأوروبية. وكذلك لم يعد سراً توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس أوباما الذي صدر عنه مؤخراً كلام أغضب رئيس حكومة إسرائيل. ومعروف أن النظرية الإسرائيلية التي تمنح أولويتها المطلقة للشأن الإيراني ولدرء مخاطره، تكتّل كل العناوين الأخرى في عنوان الإرهاب. ولئن كانت حكومة نتنياهو ماضية في رعاية الاستيطان اليهودي ومستوطناته على الأراضي الفلسطينية، فقد بات غنياً عن القول إن استراتيجيتها هي بالضبط حذف القضية الفلسطينية وتركها تموت بفعل الزمن والنسيان والشعور العامّ بالعجز عن التقدم في حلها.
إلا أن التطورات الأخيرة بدأت ترفع وتيرة النقد لنتنياهو داخل إسرائيل نفسها. حتى وزيرة العدل تسيبي ليفني رأت أن عدم دعوة بلادها لحضور مؤتمر القاهرة «شهادة على هشاشة وضعنا السياسي». ومضت في كلام مباشر عن السياسة الحكومية المعتمدة: «إنني أقول ذلك في سياق من يسوّقون لنا أن من المهم التعاون مع الدول العربية، لكنهم غير مستعدين لفعل الخطوة المطلوبة بشأن العملية السلمية(...) فمن دون مفاوضات جدية مع الفلسطينيين لا مجال لأن يكون التعاون مع الدول العربية كاملاً وحقيقياً».
وبدوره أثار القرار الرمزي للبرلمان البريطاني ردود فعل إسرائيلية حادة. فانضمت أصوات معارضة وموالية على السواء للتنديد بسياسات نتنياهو لفرضها «العزلة على إسرائيل» التي «تركت الساحة الدولية فارغة للنشاط الفلسطيني».
وبدورها فإن حركة «حماس» لا تبدو أحسن حالاً. فقد اضطرت في الآونة الأخيرة إلى تقديم تنازلات كثيرة أملى بعضها تحوّل الوضع الإقليمي، ولاسيما إطاحة محمد مرسي في مصر وتدهور علاقاتها مع دمشق وطهران، كما أملى بعضها الآخر الوضع المأساوي الذي لا يُطاق في قطاع غزة. وهكذا وافقت على شروط الدول المانحة بعد أن شاركت في حكومة الائتلاف التي تعيد السلطة الوطنية نظرياً إلى غزة. ومع هذا، لا تزال الورقة المطويّة والغامضة تتعلق بما تسميه «حماس» بـ«الحفاظ على سلاح المقاومة». فهل إعلان التمسك بهذا السلاح هو من قبيل الرغبة في الحصول على الوقت اللازم لإجراء التكيف مع الأوضاع الجديدة بما لا يصدّع الحركة نفسها، أم أنه العنوان الذي سيتم بالاستناد إليه إجهاض تلك الأوضاع والالتفاف عليها؟
ما من شك أن امتحانات كثيرة مقبلة ستتولى الإجابة عن هذا السؤال، في عدادها نوع العلاقة التي سنشهدها بين حركتي «فتح» و«حماس»، والمفاوضات التي ستجرى بين الأخيرة وإسرائيل لتبادل الأسرى أو جثامين الجنود. ولكنّ شيئين باتا مؤكدين:
الأول، أن ثمة فرصة توفرها المنطقة الهائجة لكل من إسرائيل والفلسطينيين كي يرتّبوا أمورهم بهدوء ويحدوا من تأثير الغليان والاضطراب الشاملين عليهم. والثاني، أن السلطة الفلسطينية برهنت أنها، وعلى الرغم من كل ما قيل ويقال، الممر الإجباري الوحيد لكل تقدم إيجابي قد يحصل.
عن الاتحاد الاماراتية